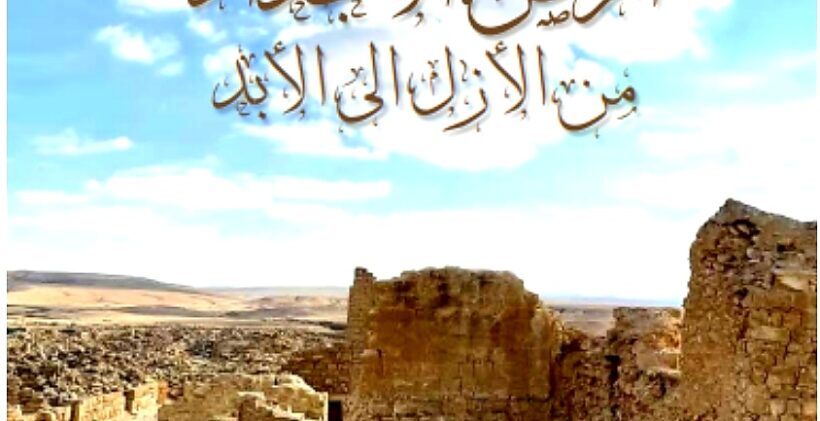نظرة تأملية في كتاب “أرض الأجداد من الأزل إلى الأبد” للدكتور علي قليبو

بقلم مراد الزير – فلسطين
يستعرض كتاب “أرض الأجداد من الأزل إلى الأبد” تاريخ فلسطين وفق علم التصوير الإنثوغرافي “Visual Anthropology” والتاريخ المقارن في تفسير أساليب الحياة المختلفة التي عاصرها الفلسطينيون من خلال توظيف أدب الرحلات في ديباجة تاريخية ذات أبعاد سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية ودينية. استوحي فيها الكاتب تجليات الفلسفة في طرح السؤال والإجابة عليه، حيث طُرحت أسئلة عدة من شخصيات تُحبّ معرفة تاريخها وتمثلت الأسئلة بالآتي: ما علاقة الفلسطيني بالأرض؟ وما مدى ارتباطه بها؟ وهل نحن السكان الأصليين؟ وما مدى وضوح الهوية الفلسطينية في حياتنا؟ كلّ هذه التساؤلات أثارت الفضول في تدوين تلك الهواجس في الذاكرة الفلسطينية لتكون ملموسةً في طيّات التاريخ ليستُذكرها الفلسطيني أينما كان، لتصبح هي الرواية التاريخية الأولى لفلسطين في سياق علم التصوير الإنثوغرافي وأدب الرحلات.
ناقش الكاتب الإرث الحضاري من خلال ربطها بالجذور واستبعد الوقوف فقط على تاريخ فلسطين منذ الفتح العُمري؛ لأن ما قبلها هو الامتداد التاريخي للحضارة الفلسطينية، موضحاً بأن الكثير من المؤرخين والباحثين يجدون أنفسهم تائهين في التفريق بين الرواية التاريخية والرواية التوراتية في الفترة التي انعدمت فيها النصوص الأدبية في تفسير بعض الحقائق، لذا حاول الكاتب تأصيل الإرث الفلسطيني من منظور إنثوغرافي وتحليل الظواهر وفق ماهيّة الحضارات، واستنباط الدلالة الرمزية وامتدادها عبر التاريخ، حيث يُطلعنا الكاتب على ارتباط الأرض في بدايتها بالآلهة الوثنية والتي تحولت لتأخذ منظوراً دينياً آخر، ليُدل على انسيابية الأديان في عملية التطور، وكان ذلك الارتباط من أجل فلاحة الأرض وتعميرها، وصلتها بالخصوبة والاحتفاظ بكل قطرة ماء والاستفادة منها، وخلال الجولات الميدانية للكاتب فقد صرّح بأن دراسة علم الأنساب والجذور التاريخية كانت تقتصر على ما قبل 800 سنة فقط أو ما يزيدها، باعتبار أن بعض سكان فلسطين هم سكان البلدان الأخرى والذين وفدوا إليها، لكن وخلال محاولته لتفنيد هذه الرواية تتضح الدراسات الجينية بحقيقة فرضيته، ومن هنا أصبح فهمنا للتاريخ بحاجة لتعمق أكثر من الاستناد إلى النصوص التاريخية فحسب، ومن خلال التجربة العالمية في دراسة الحضارات استطاع الكاتب أن يُقدّم أطروحته في الرواية الفلسطينية من خلال خبرته العلمية والتحليلية، وهذا ما يجعل كتابه منهجاً جديداً في التأريخ الإثنوغرافي والشفوي في كيفية تأريخ إنثوغرافية أرض الأجداد.
ركّز الكاتب على الزراعة واستقرار القبائل السامية، فربط حقيقة أن الإنسان الفلسطيني قد امتهن الزراعة منذ الأزل، ودجّن المزروعات وفق نظام المناخ والجغرافيا، وعليه يُستدل بأن النطوفيين هم النطفة الأولى للفلسطينيين في امتدادهم التاريخي، ومن بعدها قَدَمت القبائل السامية واستقرت في أرض فلسطين، كما استعرض الكاتب حقيقة ارتباط الزراعة بالمعتقد الديني، نظراً لصلة الزراعة بالإله “بعل”، وهكذا المقامات التي التصقت بجذور السابقين لتنقل رسالة الخصوبة في جدرانها وفي طريقة العبادة والوساطة.
وفي حديثه عن نظام الري في جبال الخليل، استطاع الكاتب أن يعطي الدلالة التاريخية لها التي تُعدُّ هي مهد استقرار الشعوب السامية والقبائل الأعرابية بعدما تحوّلت من حياة الترحال لاستقرارها على روافد المياه والأودية الممتدة لمرتفعات الخليل، الذي عزز مع الوقت ارتباطهم بالزراعة لتحويل القحط إلى بيئةٍ طبيعيةٍ لتربط الفلسطيني بأرضه من خلال امتهانه الزراعة، ولهذا استعرض الكاتب حقيقة حاجة الزراعة للمياه، مما استوحى من نظرته لتلك السفوح والأودية كيفية ترويض الأجداد للطبيعة الجغرافية من خلال طريقة الزراعة والاحتفاظ بالمياه وفق أسلوب ري احترافي متمثل ببناء سلاسل حجرية على شكل مدرجات، بحيث تمتلئ التربة خلف السلسلة الحجرية بالماء وعند امتلائها تنتقل للسلسلة الحجرية الأقل منها في الارتفاع ليُستفاد من كل قطرة ماء في ري المزروعات، وهذا النظام طُوّر في برك سليمان في جنوب مدينة بيت لحم على شكل مصاطب.
انتقل الكاتب بعد تلك الدراسة التحليلية لنظام الري في جنوب فلسطين إلى نظام الري في شمالها وخاصةً في مرج ابن عامر ومرج صانور، حيث اختلفت طبيعة الري نظراً لاختلاف الطبيعة الجغرافية، فكان الري في شمال فلسطين من خلال إغراق المرج بمياه المطر بأسلوب تقني يساعد في حفظ رطوبة التربة، كما استهل الكاتب في استعراض قيمة مرج ابن عامر في تاريخ فلسطين باعتبارها نقطة اتصال بين البلدان المجاورة كونها عُرفت بالطريق البحري، وكانت أيضاً نقطة دخول القبائل العربية لوفرة الكلأ فيها، حتى أصبح مرج بن عامر ذا أهمية تاريخية في التحالفات السياسية، ومن ثم انتقلت الشعوب المهاجرة من شمال فلسطين إلى جنوبها وفق دراسة تحليلية لأنساب تلك القبائل المنحدرة من بني لخم وبني جذامة، وفي سياق دراسة الكاتب لشمال فلسطين استعرض نفق بلعمة من خلال تقديم أطروحته لربطها بالجذور الفلسطينية باعتباره ممر سري للوصول إلى عين الماء، نافياً بذلك الإدعاءات الصهيونية حول المكان الذي يعتقدوه أنه نفق يبوسي بناه اليهود.
بعد التركيز على طبيعة الزراعة واستغلال المياه، انتقل الكاتب في إيضاح فكرة شبكة المياه من منطلق الطقوس الدينية، نظراً لارتباط أعالي فلسطين بمصدر المياه من المطر، لتتشكل بذاكرتهم مساعدة الآلهة في نزولِ المطر على الجبل الذي ينتقل ماؤها من الأعلى إلى الأودية موظفاً الفلسطيني بذلك أسلوب النقر على الصخر لتكوين الحفر الصغيرة للاحتفاظ بالمياه، وفي سياق الارتباط الديني ظهر ذلك جلياً في بعل الكنعاني، وفي مقام معلا الذي يقطنُ في أعالي المرتفعات الفلسطينية، وقد أورد الكاتب أغاني شعبية لطلب المياه من المقام معلا “واحنا طلعنا على المعلا وجينا، طلعنا المطر يا ربي أعطينا…” ليلتصق الامتداد الوثني بالذاكرة الفلسطينية وصولاً بالديانات التوحيدية المتمثلة بمقامات أولياء الله الصالحين، وقد استدلّ الكاتب على الإله بعل من خلال الأنصاب التي كانت على شكل مربع أو مثلث واصفاً امتدادها الهندسي والجغرافي والرمزي، ومن ثم تحوّلت بفعل الديانات التوحيدية لترتبط بالمقامات، وقد استعرض الكاتب أسماء المقامات التي صنّفها حسب رمزية اسم المقام المرتبط سواء بنص ديني من الكتب السماوية الثلاثة، أو بشخصيات المجاهدين أو بصلتها بقبور الأجداد، أو بمسميات جغرافية كالمكان العالي وجرن، وقد أوضح الكاتب الفرق للمعنى المزدوج للـ”جرن” وعلاقتها بالطقوس الدينية.
انتقل الكاتب للحديث عن مقام كفل حارث من خلال دراسة تحليلية لجذور الاسم وارتباطها بالامتداد الكنعاني، وامتثالها بالشجر المقدس، بالإضافة لاستعراض مقام تعمر الذي قدّم أطروحته الأولى من نوعها حول ذلك المكان نافياً الإدعاءات التي تربط اسم مقام تعمر بالخليفة عمر بن الخطاب جراء مروره بالمكان، وفق تحليله لرحلة الشتاء والصيف التي امتدت من مكة لمعان لبني نعيم للعروب للخضر وصولاً لجبل المكبر، مُؤكداً عدم مرور عمر بن الخطاب من ذلك المكان باعتباره نائياً، كما وظّف الكاتب السلوك الإنثوغرافي لسكان التعامرة في تعاملهم مع أشجار زيتون الولي الذين لا يؤكلونه، وإنّما خُصصوا زيتها للولي.
استعرض الكاتب التشكّل الطبوغرافي لبانياس وارتباطها بالطقوس الدينية وتطوراتها في ديانات عدة (كنعانية، يونانية، رومانية، بيزنطية، إسلامية، درزية)، واستلهامه الدلالات الرمزية ليُحدد طبيعة كل أثر في المكان بعلاقته الدينية. كما اهتم الكاتب في استعراض مدن الكهوف، والذي تميّز به عن غيره من المؤرخين في تحليل تلك الكهوف لتكون هي إرث الأجداد وهي الهوية الفلسطينية التي انطلق منها الفلسطيني، ليدخل الكاتب عالمها ويُحللها بأسلوب إنثوغرافي وأنثربولوجي وطبوغرافي وعمراني، ليكشف عن تفاصيل حياة الفلسطيني في تلك الكهوف بدقة متناهية.
استعرض الكاتب مدينة الكهوف “رابود” الكنعانية وأصل تسميتها، وتاريخها وطبيعة الحياة فيها عبر العصور، مستلهماً كل سلوك في ذلك المكان، سواء طقس ديني أو الدفن أو بناء سلاسل الكروم، ليكشف الغطاء بين الحياة القديمة في تلك الكهوف وعملية الحداثة في بناء مدينة جديدة تتناسب مع متطلبات العصر، كما انتقل الكاتب في وصف “الطور” ورمزيته في التاريخ الفلسطيني لارتباطها بالغزوات والقبائل الفلسطينية، واستعرض الكاتب أيضاً مدينة بيت جبرين الأدومية في تحليل واستنباط تلك التحفة الفنية الفريدة، ليصف طبيعة الحياة فيها وامتدادها التاريخي للقبائل الكنعانية التي سكنتها وفقاً لنظام عشائري في مجموعات منفصلة، وقد استطاع الكاتب بتقديم وصف دقيق للكهف من خلال استلهامه الرموز والتشكيل العمراني، ولأن الكاتب قادر على استلهام الحقائق من خلال عينه، فقد قدّم أطروحةً كاملةً حول المثلث والقمع والشكل المخروطي الذي أدرك علاقتها بطقوس قديمة، وبرموز دينية غيّبها التاريخ ليكون الكاتب نفسه مرآة لتاريخ الأجداد، ولأن الرمز مهم جداً في دراسة الدلالات، فقد استعرض الكاتب ارتباط الرموز في فلسطين في مقام أبو طوق، ليصف أولاً دلالات المكان الدينية وصلة الرموز الهندسية فيها ثانياً من خلال توظيف المنهج المقارن مع الحضارات الأخرى.
لا يقتصر الكاتب في تقديم محتوى جديد بأسلوب إنثوغرافي أنثربولوجي، فقدّ اختص في دراسة أماكن قد أهملها التاريخ، منها سبيطة عروس النقب وعبدة وكرنبة والخلصة من خلال ارتباطها بحركة التجارة ودورها في تشكيل حضارة عظيمة في النقب الصحراوي من ناحية البنية العمرانية والحياتية، كما حاول الكاتب دائماً في استعراضه لتاريخ فلسطين ربط جذور الفلسطينيين بالأدوميين الذين ينحدرون من دوما ابن إسماعيل، ودورهم في تشكيل الحضارة الفلسطينية، وقد امتثل ذلك في كهف قُصرة مُستعرضاً الأبعاد التاريخية والدينية وتحليل الرموز والمكان بدراسة علمية بحتة مُوظفاً المقاربات الحضارية في تحليل كل جزء في المكان، ولم يقتصر إلى هنا وإنما اختص في تحليل رموز الثالوث المقدس الذي يعلو مدخل الكهف، في تحليل تاريخي مُحللاً الامتداد التاريخي للثالوث المقدس لاستقرارها عند المسيحيين على شكل صليب، وقدّم الكاتب نظريته في ربط الحقائق الفلسطينية بجذورها مُعارضاً لأي محاولات لتحريف هذا التاريخ، وخصوصاً في استعراضه للملك الأدومي هيرودوس “حرد” مُقدماً حقبته التاريخية العربية ودوره العمراني في توظيف العمارة الأدومية والرومانية في أماكن عدة في فلسطين.
اختتم الكاتب بالحديث عن الصحابي تميم بن أوس الداري، ليدرس عملية الانتقال الديني والتاريخي في إيضاح أن الانتقال من الديانة المسيحية للإسلامية لم تكن لجميع الفلسطينيين وإنما لفئة معينة، نافياً الإدعاءات بأن الفلسطينيين كانوا يهوداً ثم مسيحيين ثم مسلمين، لأن هذه الرواية تزيل الارتباط بالأرض، مُستلهماً بذلك تحليله للشعوب السامية وامتدادها الديني.
تبين مما سبق بأن ارتباط الفلسطيني بأرضه منبعه الإنثوغرافية التي امتدت لجذور فلسطين التاريخية، منذ امتهان الزراعة وترويض الطبيعة واستخدام الري، وبناء المعابد وممارسة الطقوس وسكن الكهوف وإنثوغرافية الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية والسياسية ليستشعر الفلسطيني بأن وجوده أزلي أبدي، مثلما أشار الكاتب في عبارته الختامية “وتمر السنون وتبقى الذكريات تغذي الحنين، ويبقى حب الوطن إلى الأبد بلا نهاية”.